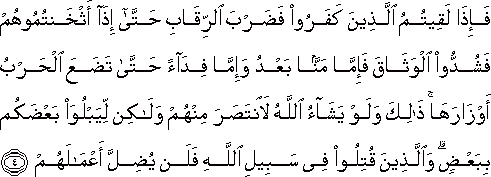- الاسلامية
- بحث القرآن الكريم بمختلف اللغات
- الدعاء من الكتاب والسنة
- مشكل إعراب القرآن
- مفردات ألفاظ القرآن الكريم
- تلاوة القرآن الكريم
- كتاب عدد آي القرآن وكلمه وحروفه ومعرفة خموسه وعشوره ومكيه ومدنيه
- ألف سؤال وجواب في القرآن
- مشروع القرآن الكريم
- أذكار وأدعيـة الصلاة
- كيف تحفظ القرآن
- حفظ سورة البقرة
- كتاب فقه السنة
- صحيح البخاري
- تغريدات #السيرة_النبوية
- قصص اﻷنبياء
- تاريخ الخلفاء للسيوطي
- العلاج بالأغذية والأعشاب
- منتخب الكلام في تفسير الأحلام
- ملاحظاتكم - الشبكة الاسلامية
- أدعية مختارة باللغتين العربية والانجليزية
- الثقافية
- الجغرافية
- الاجتماعية
- آراء
- وظائف
- خريطة الموقع
- اتصل بنا
- التسجيل
نتيجة البحث: تفسير الآية و صورتها و تلاوتها
سورة محمد آية 4
فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ۚ ذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَٰكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ ۗ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ
التفسير الميسر
فإذا لقيتم- أيها المؤمنون- الذين كفروا في ساحات الحرب فاصدقوهم القتال، واضربوا منهم الأعناق، حتى إذا أضعفتموهم بكثرة القتل، وكسرتم شوكتهم، فأحكموا قيد الأسرى: فإما أن تَمُنُّوا عليهم بفك أسرهم بغير عوض، وإما أن يفادوا أنفسهم بالمال أو غيره، وإما أن يُسْتَرَقُّوا أو يُقْتَلوا، واستمِرُّوا على ذلك حتى تنتهي الحرب. ذلك الحكم المذكور في ابتلاء المؤمنين بالكافرين ومداولة الأيام بينهم، ولو يشاء الله لانتصر للمؤمنين من الكافرين بغير قتال، ولكن جعل عقوبتهم على أيديكم، فشرع الجهاد؛ ليختبركم بهم، ولينصر بكم دينه. والذين قُتلوا في سبيل الله من المؤمنين فلن يُبْطِل الله ثواب أعمالهم، سيوفقهم أيام حياتهم في الدنيا إلى طاعته ومرضاته، ويُصْلح حالهم وأمورهم وثوابهم في الدنيا والآخرة، ويدخلهم الجنة، عرَّفهم بها ونعتها لهم، ووفقهم للقيام بما أمرهم به -ومن جملته الشهادة في سبيله-، ثم عرَّفهم إذا دخلوا الجنة منازلهم بها.تفسير الجلالين
4 - (فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب) مصدر بدل من اللفظ بفعله أي فاضربوا رقابهم أي اقتلوهم وعبر بضرب الرقاب لأن الغالب في القتل أن يكون بضرب الرقبة (حتى إذا أثخنتموهم) أكثرتم فيهم القتل (فشدوا) فأمسكوا عنهم واسروهم وشدوا (الوثاق) ما يوثق به الاسرى (فإما منا بعد) مصدر بدل من اللفظ بفعله أي تمنون عليهم بإطلاقهم من غير شيء (وإما فداء) تفادونهم بما أو أسرى مسلمين (حتى تضع الحرب) أي أهلها (أوزارها) أثقالها من السلاح وغيره بأن يسلم الكفار أو يدخلوا في العهد وهذه غاية للقتل والأسر (ذلك) خبر مبتدأ مقدر أي الأمر فيهم ما ذكر (ولو يشاء الله لانتصر منهم) بغير قتال (ولكن) أمركم به (ليبلو بعضكم ببعض) منهم في القتال فيصير من قتل منكم إلى الجنة ومنهم إلى النار (والذين قتلوا) وفي قراءة قاتلوا الآية نزلت يوم أحد وقد فشا في المسلمين القتل والجراحات (في سبيل الله فلن يضل) يحبط (أعمالهم)
تفسير القرطبي
فيه أربع مسائل: الأولى: قوله تعالى {فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب} لما ميز بين الفريقين أمر بجهاد الكفار.
قال ابن عباس : الكفار المشركون عبدة الأوثان.
وقيل : كل من خالف دين الإسلام من مشرك أو كتابي إذا لم يكن صاحب عهد ولا ذمة، ذكره الماوردي.
واختاره ابن العربي وقال : وهو الصحيح لعموم الآية فيه.
{فضرب الرقاب}مصدر.
قال الزجاج : أي فاضربوا الرقاب ضربا.
وخص الرقاب بالذكر لأن القتل أكثر ما يكون بها.
وقيل : نصب على الإغراء.
قال أبو عبيدة : هو كقولك يا نفس صبرا.
وقيل : التقدير اقصدوا ضرب الرقاب.
وقال {فضرب الرقاب} ولم يقل فاقتلوهم، لأن في العبارة بضرب الرقاب من الغلظة والشدة ما ليس في لفظ القتل، لما فيه من تصوير القتل بأشنع صوره، وهو حز العنق وإطارة العضو الذي هو رأس البدن وعلوه وأوجه أعضائه.
الثانية: قوله تعالى {حتى إذا أثخنتموهم} أي أكثرتم القتل.
وقد مضى في [الأنفال]عند قوله تعالى{حتى يثخن في الأرض} [الأنفال : 67].
{فشدوا الوثاق} أي إذا أسرتموهم.
والوثاق اسم من الإيثاق، وقد يكون مصدرا، يقال : أوثقته إيثاقا ووثاقا.
وأما الوثاق (بالكسر) فهو اسم الشيء الذي يوثق به كالرباط؛ قاله القشيري.
وقال الجوهري : وأوثقه في الوثاق أي شده، وقال تعالى { فشدوا الوثاق }.
والوثاق (بكسر الواو) لغة فيه.
وإنما أمر بشد الوثاق لئلا يفلتوا.
{فإما منا بعد وإما فداء} {فإما منا} عليهم بالإطلاق من غير فدية {وإما فداء}.
ولم يذكر القتل ها هنا اكتفاء بما تقدم من القتل في صدر الكلام، و{منا}و{فداء} نصب بإضمار فعل.
وقرئ {فدى} بالقصر مع فتح الفاء، أي فإما أن تمنوا عليهم منا، وإما أن تفادوهم فداء.
روي عن بعضهم أنه قال : كنت واقفا على رأس الحجاج حين أتي بالأسرى من أصحاب عبدالرحمن بن الأشعث وهم أربعة آلاف وثمانمائة فقتل منهم نحو من ثلاثة آلاف حتى قدم إليه رجل من كندة فقال : يا حجاج، لا جازاك الله عن السنة والكرم خيرا قال : ولم ذلك؟ قال : لأن الله تعالى قال {فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء } في حق الذين كفروا، فوالله ما مننت ولا فديت؟ وقد قال شاعركم فيما وصف به قومه من مكارم الأخلاق : ولا نقتل الأسرى ولكن نفكهم ** إذا أثقل الأعناق حمل المغارم فقال الحجاج : أف لهذه الجيف أما كان فيهم من يحسن مثل هذا الكلام؟ خلوا سبيل من بقي.
فخلي يومئذ عن بقية الأسرى، وهم زهاء ألفين، بقول ذلك الرجل.
الثالثة: واختلف العلماء في تأويل هذه الآية على خمسة أقوال : الأول : أنها منسوخة، وهي في أهل الأوثان، لا يجوز أن يفادوا ولا يمن عليهم.
والناسخ لها عندهم قوله تعالى {اقتلوا المشركين حيث وجدتموه} [التوبة : 5] وقوله{فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم} [الأنفال : 57] وقوله {وقاتلوا المشركين كافة} [التوبة : 36] الآية، قال قتادة والضحاك والسدي وابن جريج والعوفي عن ابن عباس، وقاله كثير من الكوفيين.
وقال عبدالكريم الجوزي : كتب إلى أبي بكر في أسير أسر، فذكروا أنهم التمسوه بفداء كذا وكذا، فقال اقتلوه، لقتل رجل من المشركين أحب إلي من كذا وكذا.
الثاني : أنها في الكفار جميعا.
وهي منسوخة على قول جماعة من العلماء وأهل النظر، منهم قتادة ومجاهد.
قالوا : إذ أسر المشرك لم يجز أن يمن عليه، ولا أن يفادى به فيرد إلى المشركين، ولا يجوز أن يفادى عندهم إلا بالمرأة، لأنها لا تقتل.
والناسخ لها {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} [التوبة : 5] إذ كانت براءة آخر ما نزلت بالتوقيف، فوجب أن يقتل كل مشرك إلا من قامت الدلالة على تركه من النساء والصبيان ومن يؤخذ منه الجزية.
وهو المشهور من مذهب أبي حنيفة، خيفة أن يعودوا حربا للمسلمين.
ذكر عبدالرزاق أخبرنا معمر عن قتادة {فإما منا بعد وإما فداء}قال : نسخها {فشرد بهم من خلفهم}.
وقال مجاهد : نسخها {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} [التوبة : 5].
وهو قول الحكم.
الثالث : أنها ناسخة، قال الضحاك وغيره.
روى الثوري عن جويبر عن الضحاك {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} [التوبة : 5] قال : نسخها {فإما منا بعد وإما فداء}.
وقال ابن المبارك عن ابن جريج عن عطاء {فإما منا بعد وإما فداء } فلا يقتل المشرك ولكن يمن عليه ويفادى، كما قال الله عز وجل.
وقال أشعث : كان الحسن يكره أن يقتل الأسير، ويتلو {فإما منا بعد وإما فداء }.
وقال الحسن أيضا : في الآية تقديم وتأخير، فكأنه قال : فضرب الرقاب حتى تضع الحرب أوزارها.
ثم قال {حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق }.
وزعم أنه ليس للإمام إذا حصل الأسير في يديه أن يقتله، لكنه بالخيار في ثلاثة منازل : إما أن يمن، أو يفادي، أو يسترق.
الرابع : قول سعيد بن جبير : لا يكون فداء ولا أسر إلا بعد الإثخان والقتل بالسيف، لقوله تعالى{ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض} [الأنفال : 67].
فإذا أسر بعد ذلك فللإمام أن يحكم بما رآه من قتل أو غيره.
الخامس : أن الآية محكمة، والإمام مخير في كل حال، رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وقال كثير من العلماء منهم ابن عمر والحسن وعطاء، وهو مذهب مالك والشافعي والثوري والأوزاعي وأبي عبيد وغيرهم.
وهو الاختيار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين فعلوا كل ذلك، قتل النبي صلى الله عليه وسلم عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث يوم بدر صبرا، وفادى سائر أسارى بدر، ومن على ثمامة بن أثال الحنفي وهو أسير في يده، وأخذ من سلمة بن الأكوع جارية ففدى بها أناسا من المسلمين، وهبط عليه عليه السلام قوم من أهل مكة فأخذهم النبي صلى الله عليه وسلم ومن عليهم، وقد من على سبي هوازن.
وهذا كله ثابت في الصحيح، وقد مضى جميعه في [الأنفال] وغيرها.
قال النحاس : وهذا على أن الآيتين محكمتان معمول بهما، وهو قول حسن، لأن النسخ إنما يكون لشيء قاطع، فإذا أمكن العمل بالآيتين فلا معنى للقول بالنسخ، إذا كان يجوز أن يقع التعبد إذا لقينا الذين كفروا قتلناهم، فإذا كان الأسر جاز القتل والاسترقاق والمفاداة والمن، على ما فيه الصلاح للمسلمين.
وهذا القول يروى عن أهل المدينة والشافعي وأبي عبيد، وحكاه الطحاوي مذهبا عن أبي حنيفة، والمشهور عنه ما قدمناه، وبالله عز وجل التوفيق.
الرابعة: قوله تعالى{حتى تضع الحرب أوزارها} قال، مجاهد وابن جبير : هو خروج عيسى عليه السلام.
وعن مجاهد أيضا : أن المعنى حتى لا يكون دين إلا دين الإسلام، فيسلم كل يهودي ونصراني وصاحب ملة، وتأمن الشاة من الذئب.
ونحوه عن الحسن والكلبي والفراء والكسائي.
قال الكسائي : حتى يسلم الخلق.
وقال الفراء : حتى يؤمنوا ويذهب الكفر.
وقال الكلبي : حتى يظهر الإسلام على الدين كله.
وقال الحسن : حتى لا يعبدوا إلا الله.
وقيل : معنى الأوزار السلاح، فالمعنى شدوا الوثاق حتى تأمنوا وتضعوا السلاح.
وقيل : معناه حتى تضع الحرب، أي الأعداء المحاربون أوزارهم، وهو سلاحهم بالهزيمة أو الموادعة.
ويقال للكراع أوزار.
قال الأعشى : وأعددت للحرب أوزارها ** رماحا طوالا وخيلا ذكورا ومن نسج داود يحدى بها ** على أثر الحي عيرا فعيرا وقيل {حتى تضع الحرب أوزارها} أي أثقالها.
والوزر الثقل، ومنه وزير الملك لأنه يتحمل عنه الأثقال.
وأثقالها السلاح لثقل حملها.
قال ابن العربي : قال الحسن وعطاء : في الآية تقديم وتأخير، المعنى فضرب الرقاب حتى تضع الحرب أوزارها فإذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، وليس للإمام أن يقتل الأسير.
وقد روي عن الحجاج أنه دفع أسيرا إلى عبدالله بن عمر ليقتله فأبى وقال : ليس بهذا أمرنا الله، وقرأ {حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق }.
قلنا : قد قاله رسول الله : صلى الله عليه وسلم وفعله، وليس في تفسير الله للمن والفداء منع من غيره، فقد بين الله في الزنى حكم الجلد، وبين النبي صلى الله عليه وسلم حكم الرجم، ولعل ابن عمر كره ذلك من يد الحجاج فاعتذر بما قال، وربك أعلم.
قوله تعالى {ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم} {ذلك} في موضع رفع على ما تقدم، أي الأمر ذلك الذي ذكرت وبينت.
وقيل : هو منصوب على معنى افعلوا ذلك.
ويجوز أن يكون مبتدأ، المعنى ذلك حكم الكفار.
وهي كلمة يستعملها الفصيح عند الخروج من كلام إلى كلام، وهو كما قال تعالى { هذا وإن للطاغين لشر مآب} [ص : 55].
أي هذا حق وأنا أعرفكم أن للظالمين كذا.
ومعنى{لا انتصر منهم } أي أهلكهم بغير قتال.
وقال ابن عباس : لأهلكهم بجند من الملائكة.
{ولكن ليبلو بعضكم ببعض} أي أمركم بالحرب ليبلو ويختبر بعضكم ببعض فيعلم المجاهدين والصابرين، كما في السورة نفسها.
{والذين قتلوا في سبيل الله} يريد قتلى أحد من المؤمنين {فلن يضل أعمالهم} قراءة العامة {قاتلوا}وهي اختيار أبي عبيد.
وقرأ أبو عمرو وحفص { قتلوا }بضم القاف وكسر التاء، وكذلك قرأ الحسن إلا أنه شدد التاء على التكثير.
وقرأ الجحدري وعيسى بن عمر وأبو حيوة {قتلوا}بفتح القاف والتاء من غير ألف، يعني الذين قتلوا المشركين.
قال قتادة : ذكر لنا أن هذه الآية نزلت يوم أحد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعب، وقد فشت فيهم الجراحات والقتل، وقد نادى المشركون : اعل هبل.
ونادى المسلمون : الله أعلى وأجل.
وقال المشركون : يوم بيوم بدر والحرب سجال.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (قولوا لا سواء.
قتلانا أحياء عند ربهم يرزقون وقتلاكم في النار يعذبون).
فقال المشركون : إن لنا العزى ولا عزى لكم.
فقال المسلمون : الله مولانا ولا مولى لكم.
وقد تقدم ذكر ذلك في [آل عمران ]